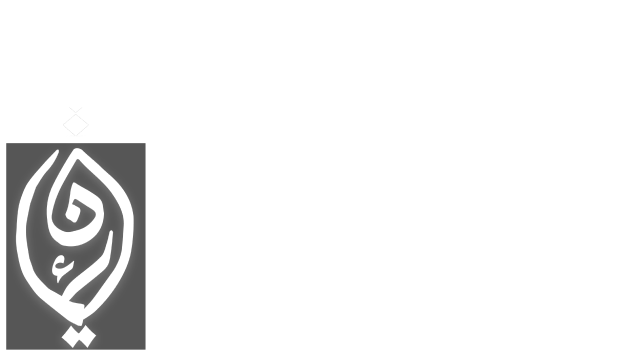بقلم: عبد الله فهيم السلهتي (خريج الجامعة الإسلامية برمنجهام)
عضو هيئة التدريس بمعهد الصفة ، برمنجهام ، بريطانيا
إمام وخطيب مسجد التقوى، كِيرِكْس لِين، برمنجهام
مقدمة
في جمادى الثانية 1446 هـ = ديسمبر 2024 م ذهبتُ في رحلة علمية مباركة مع بعض أصدقائي إلى مدينة إصطنبول العريقة. استغرقت الرحلةُ أربعةَ أيام، التقينا فيها بثُلّة من أهل العلم والمشايخ المرموقين. وكان هدفنا الرئيسُ من تلك الرحلة اللقاءَ بخاتمة المحدثين فضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد عوامة – حفظه الله تعالى وألبسه لباس الصحة والعافية – ، فاجتمعنا به لجلستين قصيرتين، ما زاد في أنفسنا شوقًا وتوقًا إلى التقابل معه مرارًا وتكرارًا، والاجتماعِ به لمدة أطولَ، حتى نستنشق من روائح كلماته العطرة، وننهل من معين علومه الغزيرة، لوقتٍ أكثرَ.
ولكن اللّه لم يُخَيِّب آمالنا، بل منّ علينا بنعمة أخرى، ما لم يكن في حُسباننا؛ إذ هيّأ لنا الاجتماعَ بنجله الأستاذ الجليل الشيخ محيي الدين عوامة – حفظه الله تعالى ورعاه ، الذي استضافنا – بمحض كرمه وفضله دونَ أيّ استحقاق منا – في مكتبه لساعات مديدة خلال تلك الأيام، وشرّفنا بنصائحه الغالية التي تُنِير لنا درب الحياة، وبمؤلفاته النافعة التي تُمَهِّد لنا سبيل العلم، فازددنا شوقًا إلى شوق لمزيد من تلك الجلسات المباركة واللمحات المستنيرة.
ولما ودّعْناه في الليلة الأخيرة من الرحلة طرأت علينا حالة هي شِبه بكاء، فأبدينا الاشتياق للُقياه في السنة القادمة، فقال لنا: «سنلقى قبل انتهاء السنة، إن شاء الله».
فكان ما قد وعد بنا الشيخُ محيي الدين، إذ تلقَّينا دعوةً خاصّة منه لحضور الملتقى العلمي الدولي الأول، الذي انعقد في جامع تشَامْليجا، بمنطقة أُسْكُدار، بمدينة إسطنبول تحت عنوان: «تعليم العلوم الإسلامية: المرجعية العلمية ومواكبة العصر»، نظمته دار الحديث العوامية، التي يرأسها أستاذنا الشيخُ محيي الدين عوامة.
جرى الملتقى على مدار يومين كاملين، (يوم السبت 15 صفر 1447 / 9 آب 2025 – يوم الأحد 16 صفر 1447/10 آب 2025)، وشارك فيه أكثر من 200 عالم فاضل، وخبير العلوم الإسلامية من خمسين دولة إلا ثلاثًا. وقد أتاح لنا هذا الملتقى المبارك فرصة عديمة النظير – هي الأولى بالنسبة للعبد الفقير – للاجتماع بعلماء ومشايخ من شتى بقاع الأرض، والاستماعِ إلى كلماتهم التوجيهية ومحاضراتهم الهادفة، لاسيما فضيلة الشيخ العلامة محمد عوامة شرّفنا بإلقاء كلمات في كلا اليومين. وما أسعد تلك اللمحات العطرة! وكم طرِبْنا حين أرعينا سَمْعنا لتلك الكلمات العبقة!
وكنتُ قد أخذت معي قَلَمًا وكُرّاسة لتدوين النقاط المهمة من محاضرات الملتقى، حتى أتمكن من استرجاع تلك المعلومات إذا احتجت إليها فيما بعد، فدوّنتُ كثيرًا من المعلومات النافعة على شكل نقاط وجُمل قصيرة، كخَريطة ذهنية. ولمّا عُدْت إلى بريطانيا طلب مني بعض شيوخي الموقّرين وإخواني المحبين أن أكتب مقالة عن تفاصيل الملتقى حتى يستفيدوا منها، فشمّرت عن ساعد الجدّ ائتمارًا بأوامرهم، وأخذتُ أرتّب تلك النقاط وأهذّبها وأجمعها في مقالة، مستعينًا ببعض تسجيلات لمحاضرات الملتقى، التي شاركها معي بعضُ الإخوان المشاركين من خلال صديقي الشيخ محمد هارون حسين – مدير مدرسة بيت النور: فرع دار الحديث العوامية ببريطانيا –.
فها هي تيك المعلومات الرائقة في ضمن مقالة قصيرة لا تتضمن مِعشار ما قُدِّم في الملتقى، بل هي غيض من فيض، أو قطرات من بحار، لا غيرُ؛ لأن كل محاضرة من تلك المحاضرات قدّمت لنا لُباب علومٍ غزيرة، وعُصارة خبراتٍ طويلة.
والله المسؤول أن ينفع بها إخواني من طلاب العلم، وهو الموفق والمعين.
اليوم الأول: الكلمات الافتتاحية
افتتح الملتقى بتلاوة من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمود طوبجو الذي أخذ بمجامع قلوب المشاركين بقراءته العذبة الهادئة، وتلاوته المجودة المرتلة.
كلمة فضيلة الدكتور محيي الدين عوامة
وإثرَ ذلك ألقى فضيلة الدكتور محيي الدين عوامة كلمتَه الافتتاحية معرِّفًا فيها بـ«دار الحديث العوامية»، تاريخِها وأهدافها ونشاطاتها المتنوعة، من الدعوة والتعليم ونشر الكتب العلمية وغيرها، وذكر فضيلة الدكتور أنه قد بلغ عدد المراكز التابعة أو المتعاونة مع «دار الحديث العوامية» أكثر من مئتي (200) مركز وجامعة، فيما يزيد على الأربعين دولة، والحمد لله. وأضاف: «ولكني لا أنكر، وأستذكر دومًا: أن الطريق كان صعبًا ووعرًا، وكلفنا الكثير الكثير، مما يحكى ولا يحكى، ولكن كان فضل الله عظيمًا.
لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنا عـلـى نعــم أتبـعتهـا نعمًا تترا
لك الحمد كم قلدتنا من صنيعـة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا»
وذكر أيضا أن العلوم الإسلامية مَبنيّة على ثلاث ركائز: (1) المنهجية (2) والتدرج (3) والتلقي، وأن جميع هذه العلوم من العربية والفقه والحديث والتفسير وغيرها مترابطة ومتعاضدة، لا يستغني أحدها عن الآخر، ولا يمكن لطالب علم أن يتخصص في أحد منها وهو عارٍ عن العلوم الأخرى.
كلمة الدكتور محمد دميروفيتش
ثم ألقى سماحة الدكتور محمد دميروفيتش – رئيس مجلس فتوى ومشيخة صربيا – كلمته عن تاريخ المسلمين في صربيا متوخياً الإيجازَ، حيث ذكر أن الإسلام دخل في صربيا من خلال الفتوحات الإسلامية، لاسيما الفتوحات العثمانية لبلاد البلقان، وكان المسلمون فيها يتبعون المذهب الحنفي في الفقه، والمذهبَ الماتريديَّ في العقيدة، إلى أن سقطت الخلافة العثمانية ودخلت الاشتراكية في تلك البلاد فهدّمت المساجد وشرّدت المسلمين، حتى إن جميع مساجد صربيا هُدِّمت خلال أربعين سنة إلا بضعة مساجد في بلغراد ، ومع سيطرة الاشتراكية والعلمانية على ساحات البلاد تسلّلت إليها الفكرة السلفية، تعيث فيها الفساد في كل جانب من جوانب الحياة.
كلمة الدكتور عجيل النشيمي
ثم ألقى الدكتور عجيل النشيمي – رئيس رابطة علماء الخليج – كلمته، مشيدًا بأعمال شيخنا العلامة الإمام محمد عوامة العلمية الهائلة، ومنجزاته الباهرة، في مجال التصنيف والتحقيق، ودعا بأن يباركَ اللهُ في عمره، حتى تزداد إنتاجاته أكثرَ ويَعُمَّ نفعها، ثم ذكر أسماءَ بعض العلماء الذين جاوزت أعمارهم التسعينَ فأنتجوا كثيرا وانتفع بهم العباد والبلاد، فمنهم: الإمام أبو يوسف والإمام الطبري والإمام ابن المبارك وغيرهم – رحمهم الله جميعا رحمة واسعة –.
وأضاف أيضا أن بعض العلماء رغم أنهم لم يُعَمَّروا طويلاً كانت إنتاجاتهم العلمية مُبهِرة، فكأنها كانت من كراماتهم، ومنهم الإمام النووي، حتى قيل: إنه لو وُزِّع ما كتب النووي في حياته كلها على عمره – الذي لم يجاوز الخمس والأربعين سنة – لكان قد كتب كل يوم خمسين صفحة، فسبحان الله من وفق علماء الأمة ما أعجز من جاءوا بعدهم! كأنها كانت من امتداد معجزات سيدنا ونبينا محمد – عليه أفضل الصلاة والتسليم –.
كلمتا الدكتور ذي الكفل البكري و الدكتور محمد أبو الخير شكري
ثم استمعنا إلى صوتيتين مسجلتين: إحداهما لمعالي الأستاذ الدكتور ذي الكفل البكري – وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق لماليزيا – اعتذر فيها عن عدم مشاركته في الملتقى، ودعا لنجاح الملتقى، والأخرى لمعالي الدكتور محمد أبو الخير شكري – وزير الأوقاف لسوريا الجديدة – وهو أيضا اعتذر عن عدم المشاركة من أجل عوائق حالت دون الحضور، وركز في كلمته على أن يكون تعليم العلوم الإسلامية جامعًا بين الأصالة والمعاصرة.
وإلى هنا انتهت الكلمات الافتتاحية وبدأ ما كنا ننتظر بفارغ الصبر، وهي الكلمة الرئيسة لشيخنا العلامة الإمام فضيلة الشيخ محمد عوامة – حفظه الله تعالى وأمدّ في عمره مع الصحة والعافية -.
الكلمة الرئيسة: كلمة فضيلة الشيخ العلامة محمد عوامة
استهلّ شيخنا كلمته العطِرة بالآية الكريمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، ثم تحدث عن أهمّية فهم لسان العصر واستخدامه في مجال التعليم والدعوة، وذكر أن اللسان لسانان: (1) لغوي (2) وعلمي وثقافي. ثم تعرض لذكر معجزات الأنبياء – عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام – لما فيها من تطبيق لسان العصر، فنرى أن الله تعالى شرّف سيدنا موسى عليه السلام بمعجزات تحدت لسان عصره وهو السحر، فاستطاع أن يعجز السحرة بمعجزاته، وأن عيسى عليه السلام كان لسان عصره هو الطب، فكرّمه الله تعالى بمعجزاتٍ –كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص – أعْيَت الأطباء، وأن سيد المرسلين نبينا محمدًا – عليه أفضل الصلاة والتسليم – بُعِثَ والعربُ في أوْج فَصاحتهم وقِمّة بَلاغتهم، فاختصّه الله تعالى بالقرآن الكريم، المعجزةِ الخالدة، التي تحدّت فصحاء العرب وبلغاءهم، فعجزوا أن يأتوا ولو بسورة مثله.
فلذا ينبغي على طالب العلم أن يكون على معرفة تامّة بواقع عصره، ويجب أن يُربَّى الطلابُ على مَهاراتِ رَدِّ شبهات العصر بعد أن تمكَّنوا في الأصول والعلوم الشرعية الأصِيلة.
وأضاف شيخنا أن هناك علمًا وأن هناك هدَفًا للعلم، ولا بد لكل علمٍ من هدَف، ومثَّل الشيخ هذا بعلم التجويد، لأنه رغم أنه أبسط العلوم لكنه أهمها وهو أسّ الدين؛ لأن الهدف منه صيانةُ الدين بحفظ القرآن الكريم الذي هو مَنبع العلوم الإسلامية طُرًّا.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الشيخ أن علم السنة له فرعان: (1) رواية (2) ودراية. فالرواية هي رواية ألفاظ السنة كما هي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأما الدراية: فهي دراسة كل شيء من الحديث سنداً ومتناً، حرفاً بحرف، كلمةً بكلمةٍ، وأردف: «علماء الحديث جُنود من عند الله سخَّرهم اللهُ ليحفظُوا دينه».
ثم ذكر شيخنا عدة قصص رائعة، وكلماتٍ غالية، لأئمتنا المحدثين، تتجلى فيها عبقريّتُهم، ودقّتُهم في التعامل مع السنة النبوية وحفظِها وصيانتِها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فمنها:
أن عبد الله بن جعفر بن خاقان السُلميّ سأل إبراهيمَ بن سعيد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق ، فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر . فقال له عبد الله بن جعفر: لا يصح لأبي بكر خمسون حديثا، من أين ثلاثة وعشرون جزءا؟ فقال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه ، فأنا فيه يتيم. («تهذيب الكمال للمزي» 1: 97).
وقال ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه». وقال يحيى بن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه»، وقال أيضا: «اكتب الحديث خمسين مرة فإن له آفات كثيرة». («الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» 2: 212)
ثم تطرق شيخنا إلى الحديث عن الفقه والفقهاء، وقال: «الفقهاء مفاخر الإسلام». ثم ذكر قصتين مدهشتين لاثنين من فقهائنا العظام:
دخل فقيه من فقهاء المالكية – وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد المغربي – بغداد فألقى عليه بعضُ العلماء مسألةَ بيوع الآجال فقال: أذكر فيها ثمانين ألف (80,000) وجه، فاستغرب فقهاءُ بغداد من ذلك، فشرع يسردها عليهم إلى أن انتهى إلى مائتين وجهًا، فاستطالوها وأضربوا عن سماعها واعترفوا بفضل الشيخ وسعة علمه. («الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 1: 449)
ومن علماء السادة الشافعية الشيخ الإمام إسماعيل المَقْري (ت 832هـ)، وقد لقيه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حين رحل إلى اليمن، فقال عنه: «هو أذكى من لقيته باليمن» وله مصنفات عديدة، بعضها متداول إلى يومنا هذا. هذا الإمام تكلّم عن مسألة الماء المشمَّس، والماء المشمَّس هو الماء الذي وُضع في الشمس فتسخن بها، وقد تنازع العلماء في حكمه: هل كراهة استعماله شرعية، بناء على ما ورد – ولم يصح – أنه يورث البرص؟ أم أن الكراهة طبية فقط؟ هذا الإمام بحث هذه المسألة في خمسة ملايين ومائة وأربعة وثمانين ألف وجه (5,184,000). قد يظن البعض أن هذا يملأ مجلدات ضخمة، لكنه رحمه الله جمع هذه الوجوه كلها في اثنين وسبعين (72) سطرًا مخطوطًا، ولو طُبع النصّ لما تجاوز ستين سطرًا فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، تطوّرُ المجتمع الإسلامي يعرف بكتب الفتاوى والنوازل، وينبغي لطالب العلم أن يكون على اطّلاع وافر على تاريخ فقهاء الإسلام العظماء؛ لأنهم القدوة الصالحة.
ثم تعرض شيخنا للحديث عن الأخوة الإسلامية، فذكر منها عدة نماذج فريدة من تاريخ الأمة الإسلامية:
يحكى عن السَّريّ السقطي – وهو خال الإمام الجنيد – أنه قال: منذ ثلاثين سنةً أنا في الاستغفار من قولي مرة «الحمد لله»! قيل له: وكيف ذلك فقال: وقع ببغداد حريق فاستقبلني واحد وقال: نجا حانوتك، فقلت: الحمد لله، فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت، حيث أردت لنفسي خيرا من الناس. («وفيات الأعيان» 2: 357)
ودخل بعضهم على بِشْر الحافي – وهو زميل الإمام أحمد – في يوم شديد البرد، وقد تعرى من ثيابه وهو ينتفض، فقال له: الناس يزيدون من الثياب فى مثل هذا اليوم، وأنت قد نقصت؟! فقال: ذكرت الفقراء، وما هم فيه، ولم يكن لي ما أواسيهم به، فأردت أن أواسيهم بنفسي في مقاساة البرد. («طبقات الأولياء لابن الملقن» صفحة 115).
وقال الإمام الشافعي:
من نال مني أو علقت بذمته سـامـحـتـه لله راجـي منـتـه
والإمام أحمد قدَمُه في العلم مثل قدمه في العمل، كان يصلي قبل المحنة ثلاثمائة (300) ركعة من النوافل – علاوة على الرواتب – وبعد المحنة واظب على مائة وخمسين (150) ركعة، وقال: «ما خرجتُ من دار أبي إسحاق – وهو الخليفة المعتصم – حتى أحللته ومن معه إلا رجلين، ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فإنهما طلبا دمي، وأنا أهونُ على الله من أن يعذب فيَّ أحدًا، أشهدك أنهما في حِلّ». («مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» صفحة 467).
وفي الختام حثّ شيخُنا طلابَ العلم على قراءة تراجم علمائنا العظام، الذين كانوا هم العباقرة حقًّا، وأن الدنيا لم تُنْجِب أمثالهم إلى يومنا هذا. فرحمهم الله جميعا وجزاهم كل خير عن الأمة الإسلامية.
وكانت كلمة شيخنا ختام المسك للجلسة الافتتاحية.
الجلسة الأولى: تكوين الملكة العلمية والشخصية القيادية
وبعد برهة من الاستراحة بدأت الجلسة الأولى للملتقى بعنوان: «تكوين الملكة العلمية والشخصية القيادية»، تحت إدارة الدكتور محمود مصري – عميد دار المخطوطات بإصطنبول -، فافتتح الجلسة قائلا: إن العلم إما: (1) بالله (2) أو بأحكام الله (3) أو بخلق الله، فالأول هو علم العقيدة، والثاني هو العلوم الإسلامية الأخرى، والثالث هو العلوم الدنيوية.
كلمة الدكتور رجب شنتورك: ما لا يسع طالب العلوم الإسلامية جهلُه من العلوم الإنسانية
وبعده تحدث الأستاذ الدكتور رجب شَنْتُوْرك – عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة – عن موضوع: «ما لا يسع طالب العلوم الإسلامية جهلُه من العلوم الإنسانية»، فصرّح الدكتورُ أن المسلمين لا يحتاجون إلى تجديد العلوم، بل يحتاجون إلى تجديد طُرُق تدريس العلوم فقط، وأكّد أن التجديد يجب أن يكون مؤصَّلا، متجذِّرًا، مَبْنِيًّا على منهج علمائنا المتقدمين، كما قال العالم الإنكليزي نِيُوْتَن لما سئل عن سبب نَجَاحه وفَشْلِ الآخرين: إني أقوم على أعناق العمالقة السابقين.
كما أكّد الدكتور على أهمِّية التركيز على المقارنة في تدريس العلوم الإسلامية، مستشهدًا بما في سورة الفاتحة من ذكر ثلاثِ أمَمٍ: (1) المؤمنين الذين أنعم الله عليهم، (2) واليهود المغضوب عليهم، (3) والنصارى الضالّين؛ وأيضًا بما في بداية سورة البقرة من ذكر: (1) المتقين (2) والكافرين (3) والمنافقين.
وأضاف أن جميع بلاد المسلمين في هذه الأيام تحت الاستعمار، إما سياسيًّا وإما ثقافيًّا؛ فمِن أجْلِ ذلك أصبح تدريسُ العلومِ الإسلاميَّةِ بطريقةٍ مقارنَةٍ من الضَّرُوريّات.
وبالإضافة إلى ذلك، أكّد الدكتور على ضرورة تدريس العقليّات في معاهدنا ومدارسنا، وصرّح بأنّا نستخدم التجربةَ ولكنّا لسنا تَجْربيِّين، وأنا نستخدم العقلَ ولكنّا لسنا عَقْلانيّين.
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الإله العرفج: التِّقِنِيّات الحديثة في التعليم
ثم تبعه الأستاذ الدكتور عبد الإله العرفج في التحدث عن موضوع: «التِّقِنِيّات الحديثة في التعليم»، فتحدث عن الذَّكاء الاصطناعي وكيفيّةِ استخدامه في تعليم العلوم الإسلامية، فقدّم عرضًا يُوضِح تطورَ الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأفعال والحركات البشرية قديماً إلى محاكاة العقل البشري حديثاً، فكأنّه أصبح مفكّراً بشَراً، وشَرح لنا الدكتورُ كيف أنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على أداء عديد من المهامّ التي قديمًا كان يؤديها البشَر فقط، مثل: الإجابة عن المسائل الشرعية بما فيها مسائل الميراث، وتلخيص الكتب والمقالات. ولكن الدكتور حذّر من أنه لا ينبغي أن يُعتمد اعتمادًا كليًّا على حُلُول وإجابات يقدمها الذكاءُ الاصطناعي؛ لأنه كثيرًا مَّا يخطئ خطأً فاحشًا، إلا أنه يتعلم بالتدريج كطالب علم يترقى في السلّم الدراسي.
وفي الختام عرض الدكتورُ قائمةً لأكثرِ برامج الذكاء الاصطناعي استخداماً، وهي:
- للنصوص فقط: (chatgpt.com)
- للنصوص أيضا: (deepseek.ai)
- للنصوص والصور: (gemini.google.com)
- من نصوص إلى صور وفيديو: (canva.com)
- لتصميم مواقع وتطبيقات: (lovable.dev)
كلمة الأستاذ الدكتور ناصر اللوغانـيّ: نحو تكوين قيادي مؤثر لطالب العلم الشرعي
ثم قدّم الكلمةَ الأخيرةَ من هذه الجلسةِ الأستاذُ الدكتورُ ناصر اللوغاني بعنوان: «نحو تكوين قيادي مؤثر لطالب العلم الشرعي»، فأكّد على ضرورة تعزيز النظام التعليمي بنظام التدريب، وتكلَّم أيضًا عن مفهوم الإحلال القيادي الذي يتضمن خطة تكتيكية تعالج فجوات المناصب القيادية التي تحدث بشكل مفاجئ نتيجة الاستقالة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة كالمرض أو الوفاة. واستشْهَد على هذا من منظور إسلامي بحادثة مشهورة من التاريخ الإسلامي، وهي غزوة مؤتة التي عيّن فيها نبيّنا – عليه أفضل الصلاة والتسليم – ثلاثَة قادة واحدًا تِلْوَ الآخر، حتى استُشهِد جميعهم ورفع راية الإسلام خالد بن الوليد، سيفٌ من سيوف الله. وإضافة إلى ذلك، القيادةُ لا تتعلق بالسن والأقدمية أو غيرهما، بل بمواصفات أخرى تمامًا، وأن التعليم يفضي إلى المعرِفة، ولكنّ التدريب يؤدي إلى تنمية المهارات، وأن المادة العلمية لا تزيد على 30 بالمائة في النظام التدريبي.
كما أن القيادة الفطرية – حسب الدراسات العالمية – لا تتجاوز واحدا في المائة، والشيخ محيي الدين واحد من هؤلاء، كذلك عدد الذين لا يستفيدون من الدورات التدريبية لا يتجاوز عن واحد في المائة. فبالتالي، الذين يستفيدون من الدورات التدريبية هم 98 في المائة. ومن هنا تظهر أهمية التدريب ومدى تأثيره في بناء الشخصية المثالية لطالب العلم الشرعي.
الجلسة الثانية: مقومات الكتب المعتمدة (1)
وبعد صلاة الظهر واستراحة الغداء بدأت الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى بعنوان: «مقومات الكتب المعتمدة (1)».
كلمة الدكتور حمرة البكري: الكتب المعتمدة في تدريس العقيدة الإسلامية .. رؤية تراثية معاصرة
فكان أول من ألقى كلمته هو الدكتور حمزة البكري – عضو هيئة التدريس في جامعة إصطنبول–، فتحدث عن موضوع: «الكتب المعتمدة في تدريس العقيدة الإسلامية .. رؤية تراثية معاصرة»، فتعرّض لأنواع الكتب في العقيدة الإسلامية وقسّمها على أربعة أقسام، فمنها:
(1) كتب التأسيس، مثل: كتاب التوحيد للإمام الماتريدي، واللمع للإمام الأشعري، والإنصاف للباقلاني. وهذه الكتب غير مناسبة للتدريس.
(2) كتب تحقيق المسائل والبحث، مثل: نهاية العقول للإمام الرازي، والتمهيد لأبي شكور السالمي، وتعديل العلوم لصدر الشريعة. وهذه الكتب هي كتب مرجعية ولكنها غير مناسبة للتدريس.
(3) كتب الترتيب والتهذيب، مثل: الاقتصاد للإمام الغزالي، ومعالم أصول الدين للإمام الرازي، وعمدة العقائد للإمام النسفي، وشرح العقائد للإمام التفتازاني. وهذه الكتب مناسبة للتدريس.
(4) كتب المتون المختصرة، مثل: العقيدة الطحاوية، وكتب الإمام السنوسي من: الصغرى والوسطى والكبرى وصغرى الصغرى وغيرها.
ثم ذكر الدكتور سِمات الكتب المعتمدة في تدريس الفن، وهي:
- استيعاب أهم مسائل الفن مع حسن العَرض والترتيب.
- والاهتمام بالأقوال المعتمدة وما قارَبَها، واجتناب الأقوال الضعيفة والشاذة.
- والثبات على مستوى علمي محدّد من المبتدئ والمتوسط والمنتهي.
- والتناسب بين مستوى العبارة والمستوى العلمي المقصود من تدريس الكتاب.
- وتوافر الكتب الشارحة والمحشِّية على الكتاب مباشرة أو بواسطة كتاب آخر، وكذا الكتب المختصِرة والملخِّصة له، وربما يُكتفى أحياناً بوجود علاقات نصية بينه وبين كتب أخرى تقوم مقام ما ذكر.
- وتداول الكتاب بين أهل العلم قديماً وحديثاً، فإن كان متداولاً في التدريس فهو أفضل، وقد تغني شهرة مؤلفه عن شهرة الكتاب أحياناً.
ثم تعرّض لعديد من كتب الفنّ التي تعاني من إشكالية عدم اكتمال سمات الاعتماد، مثلاً: أن يكون الكتاب مستوعِبا لأهم مسائل الفن مع حسن العرض والترتيب، ولكن فيها مسائل غير معتمدة، مثل: المسايرة لابن الهمام، وشرح الفقه الأكبر للعلامة علي القاري.
وأخيراً، قدّم الدكتور مقترحاتٍ ثلاثة تحتوي على مناهج للكتب المعتمدة على مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة ومنهج ممزوج بين المذهبين معاً، وتحتوى هذه المناهج على مستويات، والكتب المقررة لكل مستوى، مع الكتب المساعِدة والمواد الإضافية.
كلمة الشيخ فراز ربّاني: الكتب المعتمدة في تدريس الفقه الحنفي … رؤية تراثية معاصرة
ولما انتهى الدكتور حمزة البكري من كلمته بدأ الشيخ فراز ربّاني – المدير التنفيذي لمركز (SeekersGuidance)– حديثه عن: «الكتب المعتمدة في تدريس الفقه الحنفي … رؤية تراثية معاصرة»، وقبل الخوض في موضوعه تكلّم الشيخ عن أنواع العلماء بالنسبة للفقه، فوزعهم على قسمين: (1) العالم المتمكن في التأسيس، (2) والعالم المتخصص المتمكن في الفقه.
فأما الأول: فهو الذي يحسن فهم المسائل الفقهية، ويدرس الأساسيات، ويجيب عن عموم المسائل، ويقدر على البحث الصحيح، ويدرك أهمّية مراجعة أهل الاختصاص.
وأما سمات الثاني: فهي إحياء الدروس الخاصة للمشايخ مع التأكيد – من بعد الأساسيات – على المطالعة والبحث وقوة الصلة العلمية مع علماء متخصصين.
وأكد الشيخ على أن تثبيت الأساس أولى وأهمّ من التوسع.
ثم سرد قائمة غير طويلة للكتب المعتمدة في تدريس الفقه الحنفي، وبيّن مزايا تلك الكتب، ومستوى كل كتاب بالنسبة للتدريس، ابتداءً من «نور الإيضاح»، مروراً بأبرز كتب المتون والشروح، وانتهاءً بالكتب المرجعية وكتب الفتاوى المعتمدة.
كلمة الدكتور أمجد رشيد: الكتب المعتمدة في تدريس الفقه الشافعي .. رؤية تراثية معاصرة
وبعد أن فرغ الشيخ فراز رباني من كلمته بدأ الأستاذ الدكتور أمجد رشيد – عميد كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن – حديثَه عن: «الكتب المعتمدة في تدريس الفقه الشافعي .. رؤية تراثية معاصرة»، فتطرّق لبيان أنواع مسائل المذهب الشافعي، وطرائق التدوين، وأنواع كتب المذهب، والتسلسل التدريسي لفقه المذهب، ومعيار تقديم كتب النووي بعضها على بعض من التتبع والتقدم والتأخر.
ثم تحدث الدكتور عن عوامل مؤثِّرة في اختيار الكتب التدريسية في الفقه الشافعي، وهي:
- مراعاة قاعدة الاعتماد في المذهب بتقديم قول الشيخين، فالنووي.
- سبكُ العبارة وبعدُها عن إيهام غير المراد.
- جمعُ معتبرات المسألة من القيود والأنواع والأقسام.
- سهولة العبارة.
- اختصار العبارة مع جمع مسائل وصور كثيرة كالإرشاد والروض.
- جمعُ الأبواب الفقهية.
- التعرض للخلاف في المذهب.
وأردَف قائلًا: هذه العوامل يؤثِّر في اختيارها وتقديم شيء منها على الآخر اختلافُ أنماط الشيوخ ومراعاةُ أحوال الطلاب. وأخيرًا، ذكر الدكتور ملاحظةً دقيقةً عن متن الإمام القاضي أبي شجاع، ونحن نذكرها هنا بحرفها لعظم فوائدها:
«متن الإمام القاضي أبي شجاع الأصفهاني متقدم على الشيخين، ومع ذلك لا تكادُ تجد شافعيًّا من المتأخرين إلا وقد اعتنى به درسًا أو حفظًا أو شرحًا أو تحشيةً أو نظمًا أو قراءةً، مع أنه مختصرٌ لا يحوي كثيرا من الفروع، ويختار في مسائل كثيرةٍ أقوالا ليست هي بالنسبة للمذهب معتمدة، فليست قولَ الجمهور قبله ولا اعتمدها الشيخان بعده كحكم المبيت بمنى ومزدلفة، فضلا عمَّا في تعبيراته من إيهام غير المراد أو الإطلاق في محل التقييد أو التقييد في محل الإطلاق، فهو خارج عن بعض تلك العوامل والمعايير التي ذكرناها، لكن السرَّ عندي فيه أن اهتمام الناس فيه مبكرا كان بسبب أنه لا يكادُ يُعلَمُ في زمانه وما بعده مختصرٌ جامعٌ للأبواب الفقهية في أرباعه الأربعة ويجمع تقسيمات الباب وبعبارة سهلة مع عدم تكثير الفروع، بل يقتصر على رؤوس مسائل الباب، قال الخطيب الشربيني في مقدمة كتابه «الإقناع» (1: 4): «إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار لما كان مِن أبدَعِ مختَصَرٍ في الفقه صُنِّف، وأجمَعِ موضوعٍ له فيه على مِقدارِ حجمه أُلِّف».
كلمتا معالي الأستاذ الدكتور محمد غورمز والأستاذ بلال رجب أردوغان:
وبعد أن أتمّ الدكتورُ حديثَه ألقى معالي الأستاذ الدكتور محمد غورمز – رئيس الشؤون الدينية السابق لتركيا – كلمتَه التي كان موعدُها في الجلسة الافتتاحية، ولكنها أجِّلت إلى ما بعد الجلسة الثانية لسبب مّا، وألقى أيضا كلمةً ليست بطويلة نجلُ رئيس تركيا الأستاذ بلال رجب أردوغان، أشاد فيها بنشاطات الملتقى وركّز على التعاون بين المسلمين والأعمال المؤسساتية.
وإلى هنا انتهت الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى.
ورشة نقاشات
وبعد شيء من الاستراحة وصلاة العصر بدأت ورشة نقاشات علمية وعملية عن المواضيع التي عرضت وبحثت خلال الجلسات السابقة، وكانت هذه النقاشات في غاية الإفادة؛ لأنها عالجت كثيرًا من الأسئلة التي رُبّما كانت تدور في أذهان الحضور، فكانت فيها مشاركات من علماء كل بلد وفنّ، ما عدا الذين تفضلوا بإلقاء كلماتهم في المواضيع السالفة الذكر.
ومع انتهاء ورشة نقاشات انتهتْ برامج الملتقى ليومه الأول.
اليوم الثاني: الافتتاحية
افتتح الملتقى يوم الأحد بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ جميل عمر، من سُكّان جزيرة لَا رِيُونِيُون (وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهندي، وتتشكل جزءًا من دَولة فرنسا)، الذي أثّر تأثيرًا بليغًا على نفوس المشاركين.
الجلسة الأولى: التعليم العامّ والتعليم النُّخبَوي
ثم بدأت الجلسة الأولى بعنوان: «التعليم العام والتعليم النُّخبَوي»، تحت إدارة الأستاذ الدكتور عادل حسن حرازي اليمني حفظه الله تعالى ورعاه.
كلمة الشيخ المجتبى بن شهاب الأندونيسي: التدرج في سلم التلقي في مدارس ومعاهد شرق آسيا قديما وحديثًا
وكانت الكلمة الأولى في هذه الجلسة للشيخ المجتبى بن شهاب الأندونيسي الذي تحدث عن موضوع: «التدرج في سلم التلقي في مدارس ومعاهد شرق آسيا قديما وحديثًا»، فلمّح في البداية إلى أهمية التدرج في تلقي العلوم بنقل من الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1 : 192) بأن «الرباني»: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم وصف مصطلح «شرق آسيا» بأنه الآن تشمل عشر دول، وهي: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورا وتايلاند وفلبين وكمبوديا وفيتنام ولاوس وميانمار وبروناي.
ثم تطرّق إلى تاريخ الإسلام في شرق آسيا مصرِّحًا بأنه توجد دلالات على دخول الإسلام فيه في عهد الصحابة، وبالضبط في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه لم يكن له انتشار واسع، ثم انتشر انتشارًا واسعًا في القرن الخامس عشر الميلادي = القرن التاسع الهجري من خلال تُجّار اليمن الذين مروا على الهند، فانتشر على أيدي العلماء المعروفين بالأولياء التسعة. وسرد أسماء عدة علماء ما بعد الأولياء التسعة ممن لهم تأثير في الحركة العلمية في القرن السابع عشر، ثم القرن التاسع عشر، وصرّح بأن المسلمين في شرق آسيا آنذاك كانوا ملتزمين بالتمذهب بمذهب الإمام الشافعي وأخْذِ طريقة من طرُق التصوف.
وتأسّست في النصف الأول من القرن العشرين جمعيّتان كبيرتان في أندونيسيا وهما: جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية، والفرق بينهما أن الأولى تتميز بالتمسك بالمنهج الأصيل من تقاليد وأساليب التلقي، بينما تحاول الجمعية المحمدية التطوُّر في المقررات والأخذ بالوسائل الحديثة في التعليم، وأن الأولى تتمسك بالمذهب الشافعي في الفقه والأخرى توسعت في هذا المجال.
ثم تناول المناهج والمقررات الدراسية للعلوم الإسلامية في شرق آسيا، وختم بذكر التحديات والتوصيات، فمن التحديات:
- رغم إتقان من مشى على منهج المتقدمين لقواعد الإعراب وفروع النحو إلا أنهم لا يتقنون المحادثة باللغة العربية بطلاقة، لأن دراستهم للغة العربية هي عبارة عن أخذ القواعد وتطبيقها عند قراءة الكتب التراثية، دون أن يكون هناك تطبيق للمحادثة.
- محاولة الحكومة إبعاد الشعب عن التعليم التقليدي في المعاهد، ومحاولة شديدة في الزج بالأولاد في المدارس الحكومية.
- ضعف الاهتمام بعلم مصطلح الحديث في معظم المعاهد التقليدية.
كلمة الشيخ عبد الأحد السورتي: دروس الأمس، وتخصصات اليوم، وآفاق الغد: قراءة في النظامي الدراسي في الهند
وبعد أن أكمل الشيخ المجتبى كلمته بدأ الشيخ عبد الأحد السورتي كلمته عن موضوع: «دروس الأمس، وتخصصات اليوم، وآفاق الغد: قراءة في النظامي الدراسي في الهند»، فتحدث عن تاريخ العلوم الإسلامية في شبه القارة الهندية، بدءًا من تأسيس جامعة دار العلوم ديوبند وجامعة مظاهر العلوم بسهارنفور، فبسط في التحدث عن تاريخ هاتين الجامعتين وعلمائهما، وتصدى لمناهجهما التعليمية، وملامح الدرس النظامي، ومناهجه الممتدة لعشر أو إحدى عشرة سنة، والكتب المعتمدة فيه، وأبْرَزَ مزايا هذا المنهج من الشمول والتدرج والاهتمام باللغات (العربية، والفارسية، والأردية)، والتدريب على الترجمة، والتخصص في الحديث، وغيرها.
ثم تعرض للتحديات المعاصرة التي تواجهها معاهد الهند الشرعية من تقليص سنوات الدراسة، وحذف بعض العلوم (كالرياضيات والفارسية)، وضعف في الكفاءة العلمية للخريجين وغيرها. وقدم بعض مقترحات للتجديد، فمنها:
- إعادة النظر في كتب المنطق والفلسفة.
- تعزيز العقيدة لمواجهة الإلحاد.
- تطوير مناهج الفقه لتواكب قضايا العصر.
- وصل أصول الفقه بالاجتهاد المعاصر.
- تدريس الحديث ومصطلحه بطريقة أكثر تدرجًا ووضوحًا.
وأوصى بتدريس كتب الشيخ العلامة محمد عوامة وكتب نجله الشيخ الدكتور محمد محيي الدين عوامة في مدارس الهند والمدارس المتّبعة لمناهج هذه المدارس، التي انتشرت في أنحاء العالم من باكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا وغيرها.
كلمة الشيخ عمر فاروق قورقماز : نحو تجديد المنهج الدراسي في المدارس التركية بين الوفاء للأصالة والحاجة إلى التطور
ثم استلم الميكروفونَ الشيخ عمر فاروق قورقماز – أحد فقهاء تركيا المشهورين وعضو هيئة التدريس بمدرسة إسماعيل آغا بمنطقة الفاتح –، فتناول موضوع: «نحو تجديد المنهج الدراسي في المدارس التركية بين الوفاء للأصالة والحاجة إلى التطور» بالبحث والتفصيل، وتحدث عن تاريخ تدريس العلوم الإسلامية في عهد الخلافة العثمانية، وعن المنهج الدراسي والمقررات الدراسية وأنواع المدارس. فكان هناك مدارس عامة ومدارس تخصصية، فالمدارس العامة كان هدفها تخريج القضاة والمفتين، وكانت تسمى بحسب رواتب المدرسين: العشرينية والثلاثينية والأربعينية والخمسينية والستينية، ومنها ما أنشأه الوجهاء، ومنها ما أنشأه السلاطين، مثل صحن الثمان والسليمانية. وأما المدارس التخصصية فهي دار الحديث ودار الشفاء ودور القراء وغيرها.
وأما منهج الدولة العثمانية فكان معروفًا بـ«منهج البحر المتوسط»، وتُدرّس فيه العلوم الشرعية والعربية بكافّة أنواعها. فمن أمثلة الكتب المقررة: الكافية لابن الحاجب، والمطوّل، ومفتاح العلوم، ورسالة الآداب فى علم آداب البحث والمناظرة لطاشكبري زاده، ومرآة الأصول لمُلّا خسرو، والهداية، والوقاية، و المصابيح، وصحيح البخاري، والكشّاف للزمخشري، وأنوار التنزيل للبيضاوي وغيرها.
ومن اللافت للنظر وجودُ مادة التصوف في جميع مراحل التعليم في المدارس العثمانية، ما يُميِّز هذا المنهجَ عن مناهج العلوم الإسلامية الأخرى السائدةِ حول العالم الإسلامي، كما أن هذه المادة توجد في المدارس التركية المعاصرة أيضًا، فمن الكتب المقررة في هذه المادة كتاب «سراج المتقين» لمولانا الشيخ محمود أفندي – رحمه الله تعالى -، ومكتوبات الإمام الرباني.
وتعرض الشيخ أيضا للتحديات المعاصرة التي تواجهها مدارس تركيا الإسلامية، فمنها:
- وجود صعوبات في فهم المتون القديمة بسبب أسلوبها المعقد.
- الحاجة إلى مؤلفات تمهيدية جديدة تسهّل على الطلاب دخول علوم الشريعة واللغة.
- ضرورة تطوير المناهج بما يحقق التوازن بين التراث الأصيل واحتياجات العصر.
وإلى هنا انتهت الجلسة الأولى من اليوم الثاني.
الجلسة الثانية: مقومات الكتب المعتمدة (2)
وبعد ربع ساعة من الاستراحة بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان: «مقومات الكتب المعتمدة (2)».
كلمة الأستاذ الدكتور محيي الدين بن محمد عوامة: المنهجية في تدريس علم الحديث.. بين الأصالة والتجديد
وألقى الكلمةَ الأولى منها شيخُنا الأستاذ الدكتور محيي الدين بن محمد عوامة في موضوع: «المنهجية في تدريس علم الحديث .. بين الأصالة والتجديد»، فتحدث عن نقاط عديدة في غاية الأهمية، فذكر أن مناراتِ علم الحديث ثلاثة، وهم: الحاكم وابن الصلاح وابن حجر، وأن علم الحديث استقرّ على تقريرات ابن حجر، ورغم ذلك لا يصلح أن يكون أيّ كتاب من كتب ابن حجر مقرّرًا دراسيًّا، وأضاف أن «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر» من الكتب المرجعية في الفن ولكن ليسا من الكتب الدرسية، وكتاب «فتح المغيث» للحافظ السخاوي – تلميذ ابن حجر – كتاب مرجعي أيضا وهو أقوى وأعمق، بينما كتاب «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي كتاب أوسع وهو أيضا كتاب يصلح لتدريس الطلاب، فينبغي أن يطالع «فتح المغيث» بعد دراسة «التدريب».
ونبّه الشيخ جدًا على شروط الكتاب المعتمد في تدريس علم المصطلح وقد جعلها في نقاط وهي:
1ـ أن يكون كُتِب على ما استقر عليه العلم.
2ـ كُتِب بأسلوب سهل سلس يفهمه الطالب.
3ـ ممهدًا لكتب أئمتنا، فيبقى الطالب متصلاً بتراثنا وتحت ظلال أئمتنا ولكن بأسلوب جديد تربوي معاصر.
4ـ ثم بعد الكتابات المعاصرة يجب الدخول على كتب أئمتنا التراثية وقراءتها وحلّ ألفاظها تحت إشراف شيخ متمكن.
وهذه نقاط مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فلا يُقرأ للطالب كتاب كُتِب على منهج ابن الصلاح مثلاً، إلا بعد أن يستقرّ في العلم. وكذلك ليس كل كتاب كتب على منهج ابن حجر ـ أي بعد استقرار هذا العلم ـ يُقرأ أيضًا، فهناك كتب كُتِبت على منهج ابن حجر ولكنها مرجعية لا درسية ككتاب «فتح المغيث»، هذا لا يُقرأ للطلبة، إنما يُقرأ «تدريب الراوي» لسهولة عبارته وسلاستها، التي يستفيد منها الطالب.
ثم قال الشيخ محيي الدين ما ملخصه:
«ماذا عملنا في دار الحديث العوامية لمقررات علم مصطلح الحديث خاصة:
جعلنا الدراسة في علم المصطلح على أربع مراحل:
فكتبت ـ بعد توفيق الله تعالى أولاً ـ في المرحلة الأولى: كتاب «توضيح علم مصطلح الحديث الشريف منهج درسي بالرسم الشجري» أعَدت فيه ترتيب علم مصطلح الحديث، تخيّلت الطالب وهو يدخل علي من الباب، ماذا يحتاج إليه أولاً، يحتاج إلى الآداب، فبدأت بها، ثم طُرق دراسة الحديث، وكيفية التحمّل وما إلى ذلك من جميع ما يخصّ علم الرواية، ثم بدأت بالدراية وقسمتها إلى وجوه تنوّع علوم الحديث، وتكلّمت تحت كل وجه عن أنواعه، ليرْسم في ذهن الطالب ويشجر هذا العلم، فتشجير أي علم كان تشجيرًا واقعيًا يسهّل على الطالب رُبع العلم.
أما المرحلة الثانية: فقد أكرمني الله تعالى بأن قرأت على حضرة سيدي الوالد كتاب شيخه الخصوصي شيخنا العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله «شرح المنظومة البيقونية» – وهذا الشرح كان أكثره تلخيصا من كتاب تدريب الراوي مع إضافات يسيرة من الشيخ رحمه الله -، قرأته عليه مراتٍ ومراتٍ، وأكرمني الله بأن أقرأته أيضًا مراتٍ، فاجتمع عندي من الحواشي والنكات الشيء الكثير الكثير، فرأيت جمعها وإخراجها، ثم زدت على ذلك بأن نظرت فيما أبدع به حضرة سيدي الوالد في تعليقاته الحافلة على كتاب «تدريب الراوي» فلخصت خلاصاتها، وأضفتها في أماكنها، مع إضافة تشجيرات منوعة أيضًا، تختلف عن تشجيرات سابقه، وأعدت ترتيب الكتاب كاملاً ليوافق ترتيب الكتاب الأول «توضيح علم مصطلح الحديث» فيبقى الترتيب الذهني في ذهن الطالب مستقرًا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وسميته «الحواشي المدنية على شرح المنظومة البيقونية».
أما المرحلة الثالثة: فهو كتاب: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» بالتعليقات الحافلة التي طرز بها حضرة سيدي الوالد هذا الكتاب، فقد حرر مسائله، وأظهر مكنونه، وأبرز محاسن جماله، فاستقر به العلم وكمل، والحمد لله.
وقلت سابقًا: إن هذا الكتاب هو آخر الكتب الدرسية لهذا العلم الشريف، ولكن لا بد من ذكر ملاحظة عامة على هذا العلم:
استقر هذا العلم على مذهب السادة الشافعية، فأئمته العظام الذين قرروا وقعدوا قواعده هم من السادة الشافعية، وبهم استقر العلم وثبت، ويجب على كل طالب علم أن يدرس هذا العلم كما استقر عليه، ولكن للسادة الحنفية اختلاف مع السادة الشافعية في بعض هذه القواعد، وبناءً على اختلاف القواعد: اختلفت الأحكام، ومن الخطأ في المنهج أن آخذ قواعد السادة الشافعية في قبول الأخبار، وأطبقها على أحكام السادة الحنفية، وكذا العكس، فلكل مدرسة قواعدها التي اعتمدها مجتهدوها، ولهذا جعلت المستوى الرابع في تدريسنا لعلم مصطلح الحديث كتاب كتبته حول المسائل المختلف فيها بين الحنفية والشافعية في باب السنة وسميته: «المسائل الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية البزدوي وابن السبكي أنموذجًا» وهو لأهل التخصص العالي في هذا العلم الشريف، وخاصة للسادة الحنفية، قمت بجمع هذه المسائل الخلافية، وأوضحت فيها اصطلاح الطرفين لهذا النوع، وبعض ما ترتب عليه من مسائل فقهية خلافية، كان مرجع ذلك: اختلافهم في قاعدة التعامل مع الحديث النبوي الشريف».
ثم ذكر الشيخ محيي الدين أن مولانا الشيخ محمد عوامة يقسّم دراسة علم الحديث إلى خمسة أقسام، ذكرها سردًا، وهي: علم الحديث روايةً، وعلم الحديث درايةً، وشروح الأحاديث، وأحاديث الأحكام، وعلم الجرح والتعديل.
وقال: إن من أهمها بعد علم مصطلح الحديث: قراءة شروح الحديث لأئمتنا رضي الله عنهم، كي لا يحصل اضطراب عقدي أو فقهي عند سامع الحديث الشريف.
ولكل واحد من هذه الأقسام منهجه الخاص، وسلمه التعليمي الخاص.
كلمة الشيخ محمد عبد الله رجو: العلم النافع وأثره في التزكية
وبعد أن ختم الشيخ محيي الدين كلمته بدأ الشيخ محمد عبد الله رجو – شيخ الطريقة الشاذلية ومدير معاهد الخليل لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية – كلمته عن: «العلم النافع وأثره في التزكية»، فتحدث عن ضرورة مصاحبة العلمِ العملَ، وأن العلم النافع هو: «ما دلّك على الله وبعّدك عن نفسك»، كما قال الإمام الجنيد البغدادي، وأن من أعظم ثمرات العلم النافع تزكيةَ النفوس، وأن التزكية مقرونة بالعلم والتعليم. ومن ثمرات العلم النافع أيضا: أنه يشرح الصدر للإسلام ويزيل الشكوك، ويعين على الطاعة والخشية، ويهذب الأخلاق، ويورث التواضع والزهد في الدنيا والنصح للخلق، ويحقق الوراثة المحمدية. وهناك فرق بين علم التزكية وحالة التزكية كالفرق بين علم الصحة وحالة الصحة. وذكر نبذة عن أمراض العصر الروحانية، كرفع الخشوع، وحب الدنيا، وكراهية الموت وغيرها، وأن لا سبيل في علاجها إلا بتزكية النفوس.
والعالم الرباني هو من يعالج هذه الأمراض بحاله ومقاله، فينظم جلسات للعلم وجلسات للتزكية، وجلسات عامة وخاصة للتربية، وذكر أن أنجح المناهج الدعوية في التاريخ الاسلامي هي التي تركّز منذ البداية على عدة أمور:
- الثقة بالقدوة المتمثله بالأستاذ المربي: ثقة تدعو إلى الطاعة القلبية على بصيرة من الأمر.
- الاهتمام بالعلم الشرعي الشامل المناسب.
- الإكثار من ذكر الله مع حضور القلب؛ لأن الذكر بدون الحضور القلبي قليلُ الجدوى، كما نص عليه الإمام الغزالي في الإحياء.
- الصحبة الصالحة وحضور مجالسها من ذكر وعلم.
- القيام بالخدمة بحب وإقبال، وصدق وإخلاص، وصبر على ذلك، وثبات.
وتعرض الشيخ أيضا لأهمية الآداب في جميع مراحل الحياة.
كلمة الشيخ أدهم العاسمي: منهجية التمكن في علوم الآلة: النحو والصرف والبلاغة نموذجاً
ولما فرغ الشيخ محمد عبد الله رجو من كلمته بدأ الشيخ أدهم العاسمي محاضرته بعنوان: «منهجية التمكن في علوم الآلة: النحو والصرف والبلاغة نموذجاً»، فذكر أن هذه العلوم الثلاثة – الصرف والنحو والبلاغة – هي علوم تتوقف عليها علوم أخرى وهي لا تتوقف على أي علم آخر، فلذلك سمى الإمام السكاكي كتابه في هذه العلوم «مفتاح العلوم»، كما ذكر الإمام السنوسي في «شرح صغرى الصغرى» أن من أسباب الزيغ في العقيدة عدم المعرفة بهذه العلوم. وذكر أيضا أن مفتاح الفهم الصحيح هو القراءة الصحيحة، وهذا لا يتيسر إلا بالتضلع من علم النحو، فمن لم يُتقِن النحو فلا يوثق بعلمه. وقد صرح الإمام الشاطبي أن ألصق علم بالشريعة الإسلامية هو علم النحو. وأضاف أن علم الصرف يبحث عن بِنية الكلمة، كما أن علم النحو يبحث عن موقع الكلمة في الجُمل.
ثم أوضح أهمّية علم الصرف بضرب مثال من القرآن الكريم، وهو أن الله تعالى قال: ﴿وما ربك بظلّام للعبيد﴾، فمن لم يعرف أن كلمة ﴿ظلّام﴾ هنا للنِّسبة يظن أن الله سبحانه وتعالى نفَى كثرة الظلم فقط عن ذاته ولم ينفِ نفس الظلم.
وأكّد أيضًا أن التمكن في العلم خير من التوسع فيه، كما قال شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وأن مرحلة التخصص تأتي بعد مرحلة التمكن. ثم سرد الشيخ أسماء بعض الكتب التي تدرس في معهد الفتح بدمشق من كتب العلامة ابن هشام النحوي، وصرّح بأن آخر الكتب الدرسية في علم النحو ينبغي أن يكون «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام نفسه.
وإلى هنا انتهت الجلسة الثانية من اليوم الثاني للملتقى.
مقابلة مع فضيلة العلامة الشيخ محمد عوامة
وبعد صلاة الظهر واستراحة الغداء قُوبل المشاركون بمفاجأة ارتاح بها بالهم، وقرّت بها أعينهم، فقد كان ينتظرهم مقابلة غير متوقعة مع شيخنا فضيلة العلامة محمد عوامة، أجراها معه الدكتور عصام عيدو، فوجّه الدكتور عصام عدة أسئلة متتالية – جُلّها يدور في أذهان طلاب العلم –، فأجاب عنها الشيخ بالبسط والتفصيل.
أما كلمة شيخنا فدَارَت حول ثلاثة مواضيع: التلقي والتدرج والمنهجية، فابتدأ الشيخ جوابه عن السؤال الأول ببيتين من شعر الإمام الشافعي:
أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّـةٍ سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيـانِ
ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ وَصُحبَـةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمـانِ
فتحدث الشيخ عن ضرورة التلقي من الشيخ وطول صحبته، وشدّد على التدرج في طلب العلم، وعدم القفز مباشرة إلى الكتب الكبيرة دون تمهيد، وتأسَف قائلا بأنه قديمًا كانوا يقولون: العلم احتُضِر، وأنا أقول: الآن هو لُفّ في الكفن ودُفِن، وكل شيء له من يحميه ولكن العلم ليس له سلطان يحميه بسيفه، بل هو صار لُعبة لكل من هبّ ودبّ.
وصرّح شيخنا بأنه لو قرأ الطالب المبتدئ كتاب «مغني اللبيب» – الذي هو من كتب المستوى الأعلى في علم النحو – على أستاذ متمكن خبير يمكن أن يكفيه في هذا الفن؛ لأن صحبة الأستاذ تعرّف المبادئ والأعماق. وأضاف أن لكل علم أبوابًا ومداخل، ولا بد أن يدخل الطالب من الباب الصحيح، والتلقي من الشيوخ هو دخول البيوت من أبوابها.
وشدّد شيخنا على أن تكون البدايةُ بكتب مناسبة للمستوى، مع مراعاة البيئة العلمية للمجلس، وأنّ اختيار الكتب لا يكون لأهميته بل لصلاحيته، كصحيح البخاري؛ فإنه رغم مكانته العلمية العالية عند العلماء لا يصلح لأن يكون كتابا مناسبا لتدريس المبتدئين. ولهذا يحذّر شيخنا من قراءة غير المتأهلين وغير المتمكنين كتبَ السنة؛ فإنها لا تنفعهم بل تسبب لهم ضررا كبيرا.
ثم تحدث شيخنا عن أهمية معرفة تاريخ العلم؛ فإن تاريخ العلم يحُلّ مشكلاتِه. وذكر أن من زلّات الجامع الأزهر في القرن الماضي إدخالُ «سبل السلام» للصنعاني و«نيل الأوطار» للشوكاني ضمن المقررات في «مادة أحاديث الأحكام»، فإنهما أفسدا عقول كثير من طلاب العلم؛ لظنهم أن أحاديث الأحكام تغني عن الفقه الإسلامي. وقد سعى بعض شيوخ الأزهر اللاحقين تلافي هذه الأضرار بإدخال «طرح التثريب» للعراقي و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد في المقررات بدلا من الكتابين المذكورين، ولكن قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى.
وتابع الشيخ حديثه عن معرفة مراتب العلماء ومشاربهم ومذاهبهم، ناقلًا قول الإمام مسلم في مقدمة كتابه «الصحيح» في هذا الصدد، فتكلم عن الصنعاني وأقواله الغريبة التي خالف فيها منهج الأئمة، كتعليقه على قول سيدنا عمر رضي الله عنه «نعمت البدعة هذه»: «وأي خير في البدعة؟!»، وتحدث عن الشوكاني الذي كان يقول بحِلّ شحم الخنزيز والجمع بين ثماني عشر زوجة، وإنكار حجية الإجماع ولو لم يصرح بإنكارها في «إرشاد الفحول» بل بالإشارة إليها فقط. وأما ابن الوزير اليماني فقد صحّ منهجه في آخر حياته.
ثم تحدث الشيخ عن ضرورة المراجعة إلى الأصول وعدم الاعتماد على النقول المتأخرة، فصرّح بأن الإمام المزّي هو أشدهم انضباطاً، والملاحظاتُ والمؤاخذاتُ على كلامه قليلة جدًّا، خلافًا للحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، فالمؤاخذة عليهما أكثر بكثير. وأضاف شيخنا: لو قلنا: إن الحافظ ابن حجر أعلم بصحيح البخاري من الإمام البخاري نفسه لما كنّا مبالِغين، وبالرغم من ذلك يوجد ملاحظات على ابن حجر في إحالاته، كما يوجد في كتب الذهبي؛ لأن الذهبي كان يكتب أحيانا من حافظته وذاكرته، فمثلًا: نسَبَ الذهبي الإمام الحاكم إلى التشيع، ولكنّ هذه النسبة غير صحيحة؛ لأنها مبنية على عدم الدقة في نقل عبارة الإمام الحاكم، وليس إلّا.
وأكّد شيخنا على أنه مهما كانت إمامة القائل لا نأخذ العلم من النقل. نعم، صحيحٌ أن نِعالَ أئمتنا فوق عمائمنا ولكن العلم أهمّ وأجلّ. وأكد شيخنا قبل ختام الحديث أنه يجب على طالب العلم أن يتحلّى بالملكة النقدية، ولكن النقد يجب أن يكون مع الأدب والأدب مع النقد، فهُما مثل كِفّتي الميزان، لا يعلو أحدهما على الآخر.
وختامًا التمس الدكتور عصام من شيخنا أن يجيز المشاركين بمرويّاته، فأجاز جميعَ الحاضرين بعد أن أوصاهم بوصاياه الستّ المشهورة التي بسَطها أستاذنا الدكتور محيي الدين عوامة في كتابه الجامع الفذّ: «رحلة أوزبكستان بخدمة سيدي الوالد العلامة الإمام»، (ص 286 – 290).
الجلسة الختامية
وبعد شيء من الاستراحة وصلاة العصر بدأت الجلسة الختامية للملتقى.
كلمة الأستاذ الدكتور رضوان عز الدين: المنهجية العلمية لفضيلة الشيخ العلامة محمد عوامة
فتحدث فيها الأستاذ الدكتور رضوان عز الدين عن موضوع: «المنهجية العلمية لفضيلة الشيخ العلامة محمد عوامة» وذكر أن مؤلفات العلامة الشيخ محمد عوامة وصلت إلى أكثر من ثمانين (80) كتابا في سبعة وثلاثين (37) بابا، ثم تعرض لمنهجية الشيخ عوامة بأن من أبرز ما يركّز عليه الشيخ هو:
(1) التحقق من مصادر العلم؛ فإنه يؤكد دائمًا على أن العلم دين فلا بد من التثبّت من مصادره، ويردِّد هذه العبارة: «دينَك، دينَك، إنما هو لحمك ودمك»، وينقل قول الإمام ابن سيرين: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم»، ويقول: «الكتاب هو الأستاذ الصامت الذي يحتاج إلى أستاذ يترجم تلك الكلمات إلى حركات».
(2) معرفة مراتب العلماء من حيث ضبطُهم وعدالتُهم وأخلاقُهم وديانتُهم؛ ويضرب لهذا مثلًا بأركان علم الحديث، كمالك وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبي داود والترمذي وغيرهم.
ثم وازن الدكتور رضوان بين الإمام الدارقطني الذي يقال له: «فيلسوف الجرح والتعديل»، والميانجي الذي صنف «ما لا يسع المحدث جهله» وقال: أنّى يدرك الميانجي الذي في كتابه الضعيف والموضوع شأْوَ الدارقطني الذي صنف كتابه «العلل» في 11 مجلدًا من حفظه!
(3) خطورة التعامل مع كتب الحديث، خاصة الكتب الستة، بغير علم أو منهجية، فهي دواوين الإسلام التي وضعت للعلماء المتخصصين، لا للعامة أو أنصاف المتعلمين، ولهذا يحذر شيخنا دائمًا من أن يتناولها من لا يملك أدوات العلم فيضعِّف أو يصحِّح بغير حق.
(4) النقد مع الأدب، فلا مانع أن تكون ناقدًا، قارئًا واعيًا، لا مستسلمًا، ولكن مع الأدب. فسيدنا ابن مسعود كان يختلف معه سيدنا ابن عباس في أكثر من مائة مسألة فقهية في مجتمع المدينة الضيّق، ومع ذلك، عندما يأتي ابن مسعود، وهو راكب على الدابة، يأتي ابن عباس ليأخذ بلِجامها، فيقول: تنحَّ عنها، يا ابن عمِّ رسول الله! فيقول: «لا، هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا»، ثم ينزل ابن مسعود ويقول: «هات يدك»، فيأخذ يده ويقبلها، ويقول: «هكذا أُمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا»،.هذا هو الحب الذي يجمع الصحابة الكرام الذين ربَّاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الدكتور قول الخطيب البغدادي عن الأئمة: «إنما نحن بقل أمام نخل باسقات طوال».
وأما بالنسبة لعلم الحديث فإن الشيخ يحذر دائما من تضييق دائرته بل يدعو إلى النظر إليه نظرة شُموليّة، فمن جهة الإسناد يندرج تحته مباحث، مثل: الجرح والتعديل، والاتصال والانقطاع، والعلل الخفية. وقد صنف الأئمة في هذه الجوانب عشراتِ الكتب. وأما من جهة المتن فإنه يشمل مباحث كثيرة، مثل: غريب الحديث، وشرح الحديث، ومشكل الحديث، وأسباب الورود. وقد ألف العلماء في كل ذلك كتبا، وألفوا أيضا في الصحيح والضعيف والموضوعات وغيرها.
ومما يدعو إليه الشيخ أيضاً أن نتعامل مع نصوص السنة بحِرَفيّة لا بحَرْفِيّه، وهكذا وجدنا كثيرا ممن يتعاملون مع النصوص بحَرْفية، وجدناهم قد أخذوا إلى بُنَيَّاتِ الطريق، فنرى من يجعل الحديث الضعيف مثلًا من ضمن الموضوع ليجعلهما في سَلّة واحدة، وفي خانة واحدة. وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح علميا، فالحديث الضعيف فيه شيء من نور النبوة، وأما الحديث الموضوع فهو كلام مصنوع مُختَلَق موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بينهما في سلة واحدة! وقد ألف الشيخ رسالة هامّة في حكم العمل بالحديث الضعيف، وبيّن أن الحديث الضعيف هو على ثلاث مراتب: (1) الضعيف ضعفًا شديدًا، (2) والضعيف ضعفًا متوسطًا، (3) والضعيف ضعفًا يسيرًا. فالضعيف الذي يكون ضعفًا يسيرًا أو متوسطًا إنما سببه الضبط، والذي يكون ضعفًا شديدًا، إنما سببه الطعنُ في عدالة الرواة.
وفي الختام قال: إن شيخنا يدعو الشيخ إلى:
(1) القراءة المستمرة المثمرة وعدم التوقف، وأن يكثر من القراءة في علم الحديث.
(2) وأن لا يتعالَم على العلماء، فالشيخ دائما يردد: «غبار نعالهم إثمد لعيوننا».
(3) ويحذر الشيخ كل الحذر من قضية التوارد، وهو: أن يأخذ اللاحق عن السابق من غير تدقيق، وقد ألَّف فيه رسالة.
(4) كذلك أن لا نتطاول على علمائنا بذريعة النقد؛ ننقُد، ولكن بأدب جمّ.
(5) وأن نتعامل مع كتب أئمتنا، خاصة الكتب الستة، على أنها كتب معلَّلة، يعني: هي كُتلة واحدة، فلا ينبغي أن نأتي اليوم ونجزِّئ ونمزِّق تلك الكتب ونقول: صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي وضعيف النسائي، وصحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه؛ لأن فيه أيضا اتهامًا لذلك الإمام بأنه لا يعلم الضعاف التي في كتبه، ففيه سوء أدب مع علمائنا.
ملخص الملتقى
ولما فرغ الدكتور رضوان عز الدين بدأ الدكتور حمزة البكري بعرض ملخص الملتقى، فابتدأ الدكتور كلمته عن التراث الإسلامي، وأكد أن التراث ليس مجرد تاريخ مَضى وانقضى، بل هو علمحيّ يحمل قيمة معرفية عظيمة، مكّنته من البقاء إلى يومنا هذا. والتراث الحي لا يُستدبر أو يُتجاوز، بل يُفعل ويُستثمر، وذلك عبر الغوص في أعماقه وفهم أسراره. وهذا الغوص يحتاج إلى تيسير وتذليل، وهو ما هدف إليه هذا الملتقى.
وصرّح الدكتور بأن الملتقى سعى إلى تحقيق موازنة دقيقة بين أمرين: (1) التيسير والتذليل في مستويات التعليم الأولى، (2) والمحافظة على عمق التراث ودقته في المستويات العالية. فالمراحل الأولى هي التي تحتاج إلى تبسيط وتدرج، لتُهيئ الطالب وتُعدّه، تحت إشراف أساتذته وشيوخه، للانتقال إلى المستويات المتوسطة ثم العالية، حيث يترقى علميًا ويكتسب ملكة فقهية راسخة. أمّا المستويات العليا فيجب أن تبقى في مكانها، لا أن تنحدر إلى مستوى المبتدئين، لأن الهدف من التيسير هو الارتقاء بالطلاب، لا إنزال العلوم من عَليائها.
وأضاف الدكتور بأن مواكبة العصر محلُّها التيسير والتذليل، والوسائل والأدوات، لا الأفكار والقواعد والمنهجيات الفكرية الكبرى، فالتجديد والتطوير اللذين يدعو إليهما الملتقى يشمل:
(1) الأسلوب اللغوي: صياغة مبسطة ومناسبة لطلاب العصر.
(2) والأمثلة وتكثير الأمثلة والتطبيقات.
(3) وترتيب المواد والكتب بما يسهل التعلم والتدرج.
(4) والأسلوب التعليمي: سواء كان تلقينًا أو محاورة أو مناقشة.
وأما أصول العلم وقواعده فتبقى ثابتة، لا تمسها يد التغيير، إذ ليست مواكبة العصر أن ننقل العلوم عن وظائفها الأصيلة إلى وظائف دخيلة لا تصلح، ولا أن ندعو إلى اجتهاد متعجل قبل التمكن من الفقه وأصوله، فالاجتهاد المعاصر الحقيقي لا يكون إلا عبر إتمام الدراسة المنهجية المتدرجة، وامتلاك «فقاهة النفس» بالرسوخ في الفروع، ثم الانطلاق لحل المشكلات المعاصرة.
كما أكد الدكتور على ضرورة التمسك بالمرجعية التراثية المنضبطة على ثلاثة مستويات:
العقيدة: الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة بمدرستَيها الأشعرية والماتريدية، التي عصمت الأمة من الانحراف والشبهات عبر القرون.
الفقه: التمسك بالمذاهب المتوارثة الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) التي حفظت أعمال الناس وصححت عباداتهم ومعاملاتهم على مدى العصور.
التزكية: الالتزام بالتصوف السنّي النقيَ، البعيد عن انتحال الجاهلين ودعاوى المبطلين، لما فيه من تهذيب للنفس وتزكيتها.
وأخيرًا، صرح الدكتور بأن هذا الانضباط العلمي ليس ترفًا فكريًا، بل هو أصل الأصول الذي يصون الأمة، ويجعل العلم حيًّا يُعاش في واقعنا، لا مجرد أقوال تاريخية جافّة. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه المنهجية الروحية والأخلاقية والعلمية معًا، لتعيد للتعلم حيويّته، وللعلماء مكانتهم، وللأمة توازنها في مواجهة تحديات العصر.
النتائج والتوصيات
ثم قدّم الدكتور صلاح الدين الشامي النتائج والتوصيات التي وصلت إليها الملتقى من خلال اليومين، وصرّح بأن الغرض من الملتقى لم يكن تقديم نموذج معين، بل تبادل الأفكار والخبرات وإذكاء روح التعاون بين المدارس والمعاهد التي تتبع مناهج أهل السنة والجماعة، ثم ذكر أنه في ختام الملتقى خَلَص المشاركون إلى جملة من التوصيات، منها:
- اعتماد أسلوب يخاطب الناس بلسان العصر في العرض والوسائل، مع الحفاظ على المنهج العلمي الأصيل.
- ضرورة تدريس العلوم الإسلامية بما يعزز ثقة الشباب بدينهم، من خلال أساليب تدريسية لا تقتصر على فك العبارة وظاهر الألفاظ، بل تغوص فيما خلف ذلك مما يحقق مقاصد العلم ويرسّخ فهمه.
- دمج التدريب على المهارات العلمية والحياتية في البرامج الدراسية، لتخريج طالب علم متكامل الشخصية.
- إعداد مصنّفات واضحة في «ما لا يسع المسلم جهله» من العلوم الإنسانية، ليكون الطلبة على وعي بواقعهم ومحيطهم.
- اعتماد سلاسل علمية متدرجة، بناء على المعايير التي ذُكرت في سمات الكتب المعتمدة، ويستفاد كذلك من النماذج التي اقترحها السادة العلماء والأساتذة الكرام في موضوعات علم الكلام والفقه الحنفي، والشافعي، والحديث، واللغة، وغير ذلك.
- تطوير المناهج والبرامج بما يضمن حيويتها، دون المساس بأصولها الراسخة.
- العناية الخاصة بعلوم الآلة وعلوم اللغة، وأن من أهم مشكلات برامج العلوم الإسلامية الضعف في تأصيل الطالب في علوم الآلة
ثم صرح بأن هذا الملتقى لم يكن مجرد اجتماع أكاديمي، بل كان مناسبة لالتقاء القلوب قبل العقول، وتجديد العهد بخدمة العلم وأهله، والتواصي على البر والتقوى والتعاون فيما رفعوا من شأن العلم وطرق تدريسه، وفي الختام دعا للقائمين على الملتقى والمشاركين فيه أن يبارك الله في جهودهم، وذكّر الحاضرين بأن لا ينسوا إخوانهم المجاهدين في غزة العزة وفلسطين الأبية.
الكلمة الأخيرة : من رئيس دار الحديث العوامية
ثم اختتم الملتقى بالكلمة الأخيرة من رئيس دار الحديث العوامية الشيخ الدكتور محيي الدين عوامة – حفظه الله تعالى ورعاه – التي شكر فيها جميع المشاركين، ودعا في كلمته علماء أهل السنة والجماعة إلى اجتماع كلمتهم وقال: «فالاجتماعُ قوةُ كيانٍ، وإبرازُ منهجٍ، بل أقول: فرضُ منهجٍ، وسيطرةُ فكرٍ، وكم نحن أهلَ السنةِ والجماعة، بحاجة إلى هذا التعاضُدِ والتلاحم، والتشاورِ مع أكابرِنا دومًا والتباحث، والعمل الدؤوب في خدمةِ دينِ الله تعالى، وسنةِ رسولِه محمد صلى الله عليه وسلم، على نهجٍ علميٍّ صحيحٍ سليم، فكلٌّ منا موقوفٌ محاسب، مسؤولٌ عن ثَغرتِه التي أوكلَه الله بها، وأقامَه عليها، فـكلُّ رجلٍ من المسلمين على ثَغرةٍ من ثُغَرِ الإسلام، اللهَ الله لا يؤتى الإسلامُ من قِبَلك».
بعض المشايخ الذين تقابلنا معهم خلال اليومين
من المغانم التي أنعم الله علينا في هذه الرحلة هي مقابلةُ عدد كبير من المشايخ والعلماء والفضلاء الذين لم يكن لنا سبيل في لقائهم والاجتماع بهم في مجلس واحد إلا من خلال هذا الملتقى العلمي المبارك، وربما يحتاج طالب العلم إلى زيارة عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للفوز بهذا النوع من الفرصة الذهبية. وهأنذا أذكر جملة من المشايخ والعلماء والأكاديميين الذين تشرفت بمقابلتهم ومحاورتهم والتعرف عليهم شخصيًّا والاستفادة منهم مباشرةً، فمنهم:
الدكتور عبد الإله العرفج
تشرفت بالاجتماع بالدكتور عبد الإله العرفج في اليوم الأول من الملتقى بعد أن ألقى كلمته عن استخدام التقنيات الحديثة في مجال تعليم العلوم الإسلامية، وهو من المشايخ المعروفين والعلماء المشهورين من مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية، وكان من أماني العبد الفقير – منذ أن طالعت كتابه «مختصر مفهوم البدعة» – أن أتقابل مع الشيخ وأستفيد منه مباشرة، فلما أتيحت لي الفرصة اغتنمته وتقدمت إلى الشيخ في إحدى الاستراحات وأهديت إليه كتابين لفضيلة والدي الشيخ مولانا محمود حسين السِّلْهتي البنغلاديشيّ، وهما: «فتح البصير في أصول التفسير»، و «تحفة الأخيار بما في الكتب الستة من المصاريع والأشعار»، فتقبّلهما الشيخ برحابة الصدر، وأخبرني أن كتاب «مفهوم البدعة» – وهو أصل «المختصر» المذكور – قد نَفِد من الأسواق. ولكنَّا حصلنا على نسخة من كتابه الجديد «مختصر المناهج الفقهية المعاصرة» الذي طبعته دار الحديث العوامية ووزّعت نسخها مجّانا بين المشاركين في الملتقى.
الدكتور ناصر اللوغاني
تشرفت بمقابلة الدكتور ناصر بن خليفة بن أحمد اللوغاني أيضا في إحدى الاستراحات، وهو أستاذ مشارك بقسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، فلما أخبرته أني أسكن ببريطانيا أفادني أنه يزور بريطانيا أحيانا، وعندما يأتي إلى بريطانيا فهو يجتمع بصديقه الشيخ سليم دهورات. والشيخ سليم من المشايخ المعروفين في بريطانيا ومؤسسُ ومديرُ مجمع الدعوة الإسلامي بمدينة لِسْتر. ثم أهديت إلى الدكتور كتابَي فضيلة والدي المذكورين فأهداني كتابه: «الفروق بين مصطلحي الدعوة والإنكار من حيث خاصية الإلزام والاختيار: دراسة مقارنة في المصطلح الدعوي القرآني»، فحظيت بنعمتين في آن واحد، وهو اللقاء بالدكتور واستلام أحد مؤلفاته النفيسة.
الشيخ فراز ربّاني
التقيت بالشيخ فراز ربّاني في اليوم الثاني من الملتقى مع صديقي الشيخ محمد هارون حسين. والشيخ فراز من سكان كَنَدا، أصله من الهند، وهو المدير المؤسس لمعهد «سيكيرز» (Seekers Guidance)، فجلسنا معه نتحادث عن علماء الشام وذكرياته أيامَ دراسته في بلاد الشام، فتحدث إلينا عن المشايخ الذين تخرج عليهم، وأعلمنا بنبذة من أخباره الطريفة مع شيخ مشايخنا مفتي باكستان السابق العلامة الشيخ محمد رفيع العثماني – الأخ الأكبر للعلامة محمد تقي العثماني -. ولما أبدينا رغبتنا في اصطحابه معنا لزيارة مشايخ الشام المقيمين في إصطنبول رضي بذلك وحدّد لنا موعد اللقاء، ولكن قدر الله شاء لنا شيئا آخر فلم نستطع أن نلقى به تلك المرة، ولئن شاء الله فلأقابلنّه في المرة القادمة. وكنت قد أهديت إلىه أيضا كتابي فضيلة والدي، فأعجب بعنوان: «تحفة الأخيار بما في الكتب الستة من المصاريح والأشعار»، وقال: يبدو أنه أول كتاب في هذا الباب.
الشيخ محمد عبد الله رجو
لقينا في اليوم الأول من الملتقى في استراحة الغداء بأخ مَرْعَشيّ، اسمه الشيخ طارق المحمد، فتجاذبنا أطراف الحديث، والتقطنا صورا في ساحة «جامع تشَامْليجا». ولمّا أفادنا أنه من مريدي فضيلة الشيخ محمد عبد الله رجو (حفظه الله تعالى ورعاه) – وقد كنت تعرَّفت على الشيخ من خلال منشورات محبيه ومريديه عبر وسائل التواصل الاجتماعي – طلبت من الأخ طارق أن يعرِّفني على الشيخ حتى أتشرف بصحبته وطلب الدعاء منه. فلما رجعنا إلى قاعة الملتقى بعد الاستراحة أخذ بي الشيخ طارق المحمد إلى شيخه، فقدمت إليه كتابَي الوالد وطلبت منه الدعاء، فرحب بي الشيخ وطلب مني أن أبلغ سلامه إلى الوالد.
الشيخ أدهم العاسمي
الشيخ أدهم العاسمي من المشايخ المعدودين الذين كنت أتمنى دائما أن أقابلهم في حياتي ولو مرة واحدة؛ وذلك لأني كنت أتابع بعض دروسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنّي أشجع تلاميذي في «معهد الصفة ببرمنجهام، بريطانيا» على متابعة دروسه؛ تنميةً لمهارتهم في اللغة العربية. فكان الاجتماع بالشيخ أدهم العاسمي فرصة نادرة. ولما اقتربنا من الشيخ وجدنا حَوله شبابا وطلبة العلم من بلاد ما وراء النهر وخراسان، وكان الشيخ يحدثهم وينصحهم، ويمشي أحيانا، ويقف أحيانا والسُّبْحة في يده، وحينما يتحدث فكلامه واضح جليّ لا يواجه السامع أي مشكلة في فهمه وإدراكه. وتشرّفت بإهداء كتابي الوالد إليه أيضا.
الشيخ مجد بن أحمد مكي
الشيخ مجد مكي من المشايخ الذين استمتعت بدروسه كثيرا، لاسيما حلقاته مع شيخنا فضيلة العلامة محمد عوامة على كتابه: «معالم إرشادية»، وبما أني نشأت على حب قراءة كتب شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله – أحببتُ دائما أن أجتمع بتلاميذه الكبار، ومنهم الشيخ مجد مكي حفظه الله، فأنا دائما أتابع صفحة الشيخ على موقع الفيسبوك وأستفيد من منشوراته القيمة. فلما علمت من صديقي الشيخ محفوط أحمد السلهتي أن الشيخ مجد مكي حضر الملتقى بدأت أتحيّن الفرصة للاقتراب منه. وكنت قد حجزت نسخة من كتابي الوالد للشيخ، فلما أتيحت لي الفرصة تقدمت إليه وقدّمت إليه الكتابين، فأخذهما وبدأ يتصفّحهما، فأعجبه الكتابان، لاسيما «تحفة الأخيار بما في الكتب الستة من المصاريح والأشعار»، فإن الوالد حقق فيه مسألة التوسّل بالنبي عليه الصلاة والسلام تحت شعر أبي طالب: (وأبيض يستسقى الغمام بوجهه…)، فـرَاقَهُ هذا البحث. فأرسل إلي رسالة عبر الواتساب فوراً أنه راغب في تحصيل مؤلفين آخرين للوالد، وهما: «مواهب الرحمن في أصول التفسير وعلوم القرآن» و «تحفة الأعلام بما صحيح البخاري من الخلل والأوهام»، فأخبرته أن الأول منهما قد نفد والوالد يُعِدُّ الآن الطبعة الثانية منه، وأما الثاني فهو الآن تحت المراجعة النهائية.
وإني إذ أكتب هذه المقالة فقد انتهى فضيلة والدي عن المراجعة النهائية من الكتابين وهما ينتظران مَنْ يطبعهما وينشرهما في البلاد الإسلامية والعربية؛ ليعُمّ نفعهما ويستفيد منهما أهل العلم من العرب والعجم، والله المستعان وعليه التُّكلان.
الدكتور عادل حسن حرازي اليمني
ومن خلال الشيخ مجد مكي تعرّفنا على شيخ آخر جليل متواضع، وهو الشيخ عادل حسن حرازي اليمني، وهو يسكن الآن في قطر. اجتمعنا به في إحدى الاستراحات وسلَّمنا عليه، ولما انتهى الملتقى وذهبنا إلى الفندق وصلتْ إلي رسالة من الشيخ مجد مكي عبر الواتْساب أن صديقا له – وهو الشيخ عادل – يرغب في حصول كتابي الوالد، فاتفقنا على أن أدع الكتابين في مكتب مؤسسة إدّف (في منطقة الفاتح) وهو سيأخذها عندما يذهب إليه بعد يوم.
ولما عدنا إلى برمنجهام وخرجت في اليوم التالي أمشي في شوارعها قابلتُ أحد مشايخي الأولين في مدينة برمنجهام – وهو الشيخ محمد السعيدي اليمني – فسألني عن جديد من أخباري، فأخبرته عن رحلتي إلى إصطنبول ولقاء المشايخ، وخصصت منهم بالذكر الشيخ عادل حسن لكونه يمنيّا، عَلّه يعرفه، فعرفه توًّا وقال: إنه صديق لي، درس في معاهد الهند من جامعة ندوة العلماء وغيرها، وكان أبوه صالحا، توفي وهو في السجود.
وفي اليوم التالي وصلتني صورة من الشيخ محمد علي المسعود – الذي تعرّفنا عليه في مكتب مؤسسة إدّف، والذي اصصحَبَنا في جولةِ يومٍ كاملٍ حول الأماكن التاريخية من مدينة إصطنبول العتيقة – عبر الواتساب يظهر فيها الشيخ عادل حسن في مكتب مؤسسة إدّف. ثم أرسل إلي رسالة عبر الواتساب يبدي فيها إعجابه بكتاب «تحفة الأخيار بما في الكتب الستة من المصاريح والأشعار» قائلا:
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الحبيب الشيخ عبد الله فهيم، حفظك الله وبارك فيك وكتب أجرك وجزاك خير الجزاء، أشكرك على هذين الكتابين، وسلامي وتحياتي للوالد الكريم مولانا الشيخ محمود – جزاه الله خيرا –، أعجنبي جدّا فكرةُ كتاب «تحفة الأخيار»، فِكرة رائعة متميزة، فلَه خالص شكري وتقديري ودعواتي».
الدكتور أحمد صنوبر
التقينا في اليوم الثاني بأحد علماء الحديث والأكاديميين المتميزين في هذا العصر، وهو الدكتور أحمد صنوبر، وقد كنت سمعت عن صفاته الكريمة ومؤهلاته الفائقة من صديقي الشيخ محفوظ أحمد السلهتي، فكنت أشتاق لرؤياه والاستفادة من الاجتماع به، وكنت قد قرأت بعض الأجزاء من كتابه «من النبي ﷺ إلى البخاري» الذي طبقت شهرته الآفاق، فأعجبت به وصرت من المحبين للدكتور أحمد. وكان اللقاء به طريفًا، حيث إننا اقتربنا من الدكتور حمزة البكري – الذي قابلناه في رحلتنا السابقة إلى إصطنبول – لنسلم عليه وكان على يمينه شخص آخر، فسألت الدكتور حمزة عن الدكتور أحمد صنوبر مبدياً رغبتي في اللقاء به، ولكني ما رأيت الدكتور أحمد قبل ذلك ولم أرَ صورته أيضا، فأجاب الدكتور حمزة متبسماً: إنه قد ذهب إلى مكان بعيد، بعيد جدّا من ههنا! فعرفت أن الدكتور يمزح بنا وأن الذي على يمين الدكتور حمزة هو الدكتور أحمد صنوبر. ثم قدمت إليه كتابَي والدي فرحب بهما وسألني: هل عندكم كتبي؟ فلما أجبته بالنفي قال لي: خذوا مني كتبي غدًا من معرض الكتاب العربي الدولي الذي ينعقد الآن في إصطنبول. فذهبنا في اليوم التالي إلى المعرض وحصلت على كتابين له، وهما: «من النبي ﷺ إلى البخاري» و«السلطة السياسية وحركة رواية الحديث ونقده». فجزاه الله كل خير.
مشايخ وعلماء آخرون
وسعدنا أيضا بلقاء مشايخ آخرين، فمنهم أخص بالذكر: الشيخ عمر فاروق قورقماز، الذي تحدث عن المناهج الدراسية في مدارس الدولة العثمانية ومدارس تركيا، وهو يدرس بمدرسة إسماعيل آغا بمنطقة الفاتح، وقد دعانا الشيخ إلى زيارة المدرسة ولكنه اعتذر قائلا بأنه سيسافر إلى مدينته طرابزون لكامل شهر إثرَ اختتام الملتقى، فوعدناه أننا سوف نزور المدرسة في الرحلة القادمة، إن شاء الله.
وسلّمنا أيضا على الشيخ صلاح الدين الشامي وأخذنا رقم هاتفه، والشيخ البراء بن العلامة عبد الملك السعدي – حفظهما الله ورعاهما –، وتعرفنا أيضا على الشيخ عبد الأحد السورتي (من كجرات، الهند) وشرّفّنا الشيخ بإهداء كتاب له، نقله إلى العربية وحقّقه، وهو «إنسان العين في مشايخ الحرمين» للشاه ولي الله الدهلوي)، والشيخ جميل عمر (من جزيرة لا ريونين)، والشيخ رياض الهدى (من ولاية ميشيغان، الولايات المتحدة)، والشيخ محمد هارون عباس عمر (من دار الحديث العوامية، جنوب أفريقيا)، والشيخ أويس بن وسيم علي (الذي يشتغل بطلب العلم في مدينة قونية، وأصله من أستراليا)، والشيخ عطاء الله هاشم (طالب الدكتوراه بجامعة ابن خلدون، أصله من بنغلاديش الحبيبة، والذي أهدى إلينا كتاب «في صحبة الشيخين» في المعرض، فجزاه الله كل خير).
الخلاصة
مما لا شك فيه أن الملتقى العلمي الدولي الأول كان فرصةً نادرةً للمشاركين والمحاضرين، من حيث تنوّعُ المواضيع المفيدة، وتفنّنُ الكلمات الهادفة، وغزارةُ المعلومات النافعة. والحقّ أن الملتقى كان منقطع النظير، بل أول من نوعه – فيما أعلم –، من حيثُ إنه أول ملتقى دولي يُعالج المشاكلَ والتحديّاتِ التي تواجهها المعاهد الشرعية والمدارس الإسلامية التي تسلك منهج علمائنا السلف وتنهج النهج «المشيخي» بدل المنهج الأكاديمي.
وممّا زاد الملتقى جمالًا وبهاءً، ورونَقًا و ورُواءً، حسنُ التنظيمِ وجمالُ الإبداع، وجودةُ الإدارةِ وروعةُ الإلقاء، والتنوّعُ في اختيار المواد والمواضيع، ومشاركةُ المحاضرين من مختلف الأصقاع وشتى البقاع. فمن مظاهر حسن التنظيم وجودُ جلسات متعددة، كل جلسة لها موضوع خاصّ ومدير مختلف ومحاضرون متنوعون، ما لعب دورا هامًّا في جذبِ انتباه الحاضرين ولفْتِ أنظارهم إلى المحاضرات. ومن مظاهره أيضًا وجودُ استراحات قصيرة وطويلة، ووجباتٍ خفيفة، بين الجلسات ما ساعد في تنشيط الأذهان وإزالة الإرهاق من المشاركين والمحاضرين.
وممّا أدهشني كثيرًا – وأدهشَ كثيرا من الحضور – مشاركةُ فضيلة شيخنا العلامة محمد عوامة في جلسات الملتقى كلِّها، من البداية إلى النهاية، والإصغاء إلى المحاضرين الذين هم تلامذتُه أو تلامذةُ تلامذتِه أو أمثالُهم، رغم كِبر سنّه وعدم استقامة صحته، والذي – لا شكّ – يدلّ على كمال تواضعه، وشخصيته الفذة، مع أن الله تعالى رزق له القبولَ في جميع أنحاء المعمورة، بين الخاصة والعامة.
ومن اللافت للنظر أيضًا، والذي يسترعي الانتباهَ ويستحقُّ التقديرَ، مظاهرُ من تواضع وانكسار أستاذِنا الشيخ محيي الدين عوامة طوالَ يومين للملتقى وترحيبُه للمشاركين برحابة صدر؛ فإنه رغم كونه رئيس دار الحديث العوامية – التي نظمت الملتقى – لم يكن له أيّ ظهور في المنصة إلا لدقائق معدودة، لإلقاء كلماته الافتتاحية والاختتامية. وأما كلمته التي ألقاها حول موضوع تدريس علوم الحديث فكان فيها كأحد أصحاب المحاضرات الآخرين، مقيَّدا بوقته المحدّد، دون أن يجاوز ذلك أو يطلبَ مزيدا من الوقت.
فالخلاصة، أن الملتقى لم يكن مجرد ملتقى علمي محض، بل كان فرصة نادرة لاجتماع دروس العلم والأدب والعمل الصالح، والاحتكاك بالعلماء والمشايخ وطلاب العلم، وقضاءِ سُويعاتٍ مشرقة مع أحد أعلام هذا العصر، وهو شيخنا فضيلة العلامة الإمام الشيخ محمد عوامة – حفظه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه –، والاغترافِ من معين علومه الصافية. فجزى الله القائمين على الملتقى كلّ خير، لا سيما أستاذنا الدكتور محيي الدين عوامة، ووفّقه لمزيد من الأعمال النافعة التي تخدم العلمَ وأهله، والدينَ وأتباعه. آمين يا رب العالمين.